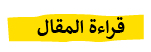تمرّ غداً الذكرى السابعة للمجزرة الكيماوية في غوطة دمشق، وهي المجزرة التي استُخدِمَ فيها غاز السارين لاستهداف مناطق مكتظة بالمدنيين. كان هول ما جرى فوق كل احتمال، وأسوأ من كل كوابيس من عاشوه. لم تكن تلك الضربة هي الأولى من نوعها على الغوطة، فقد تعرضت بلدات فيها للاستهداف بالسلاح الكيميائي قبل ذلك، لكنّها كانت الضربة الأوسع، والتي تسببت بمجزرة هائلة قضى ضحيتها 1466 شهيداً، وأصيب الآلاف إصابات لم تكن معهودةً على هذا النطاق الواسع، ما وضع الكوادر الطبية وأجهزة الإنقاذ في المنطقة في حالة صدمة لا يمكن أن يتصورها أحد.
ليس من السهل أبداً استرجاع تلك الذكريات بالنسبة لمن عاشوها، فهي تَذُّكرٌ لما قد يكون أسوأ لحظةٍ عاشها إنسان، لكنّ استمرار نظام الأسد وحلفاءه، بالتحديد روسيا، في محاولات التضليل وتشويه حقيقة ما جرى، دفع الضحايا إلى الإصرار على مواجهة تلك الفظائع مرة أخرى ورواية ما جرى، وكتابة شهادات عن لحظات هاربة من الجحيم، عاشها سكان مدنيون محاصرون كان ممنوعاً عليهم إدخال أي من الحاجات الأساسية مثل الغذاء والأدوية الرئيسية والمحروقات، في حين قُطعت عنهم كل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، متروكين لوحدهم في مواجهة غول توحش النظام الذي كانت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أداته الوحيدة في مواجهة انتفاضة الناس وثورتهم عليه.
هذا النص هو شهادة من حسن محمد، المصور الخاص النقطة الطبية رقم واحد في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وهي واحدة من عدّة نقاط طبيّة في عموم الغوطة استقبلت مصابي وشهداء تلك المجزرة. يحاول حسن، الذي عمل أيضاً مصوراً صحفياً لصالح وكالة فرانس برس، استعادة تلك الكارثة التي كان شاهداً عليها، من خلال سرد تفاصيل الساعات التي تلت المجزرة واستقبال النقطة الطبية للمصابين. قرابة اثنتي عشر ساعة كانت كفيلة بتغييرنا جميعاً من دون رجعة.
– المحرر
حسن محمد
«أبو علي.. أبو علي»، جاء الصوت المرتجف لصديقي ثائر، مع ضرباته السريعة على الباب، فأيقظني من نومي بعد منتصف ليل الحادي والعشرين من آب (أغسطس) 2013. «هناك سبب وحيد يدفع ثائر ليأتي إليّ بعد منتصف الليل»، فكرتُ وأنا أخرج مسرعاً لملاقاته، «بالتأكيد إنها مجزرة».
نحن نعيش في منطقة الغوطة الشرقية، في مدينة دوما حيث عشت كل حياتي حتى تهجيري منها عام 2018. دوما مدينة صغيرة، تبعد عن العاصمة تسعة كيلومترات، وقد كنتُ فخوراً بمشاركة مدينتي في الثورة منذ آذار 2011. نتيجة ذلك تعرضَت المدينة لحملات من المداهمات والاعتقالات وعمليات الإعدام الميداني واستهداف المتظاهرين على مدى سنتين، حتى تحرير المنطقة من قوات النظام السوري أواخر العام 2012.
كنا خلال تلك الفترة، نقوم بتوثيق ما يحدث حتى تصل الأخبار إلى القنوات الإخبارية والمنظمات الحقوقية، وخلال تلك السنوات تعززت معرفتي بصديقي ثائر، وهو شاب يدرس الحقوق في جامعة دمشق. ومع تحرير أجزاء واسعة من الغوطة الشرقية أواخر 2012، كان بمثابة الأخ والصديق المقرب، بعد خرج كثيرون من أقاربي وأصدقائي من سوريا في تلك المرحلة.
خلال اللحظات القليلة التي سبقت وصولي إلى الباب، كنت أحاول توقع الاحتمالات، وكعادتنا، حاولت التفكير في أسوئها؛ إما مجزرة في مخيم الوافدين، المعبر الذي يفصل بين دوما المحاصرة تماماً منذ بداية العام 2013 وأوتوستراد دمشق حيث تتموضع قوات النظام في المنطقة، وتطلق النار باتجاه أي مدنيين يحاولون الفرار من الحصار باتجاه دمشق أو يحاولون الحصول على بعض المواد الغذائية. غالباً ما كانت تلك المحاولات تتم قرب منتصف الليل، بهدف الاستفادة من الظلام الدامس.
الاحتمال الثاني الذي خطر في ذهني، وحاولت طرده خوفاً، أن يكون هجوماً بالسلاح الكيماوي، فقد سبق أن قام النظام السوري بشن عدة هجمات كيميائية سابقة على منطقة الغوطة الشرقية. كانت أولى الحوادث التي شهدتُ إسعاف مصابيها في الرابع والعشرين من آذار 2013 في النقطة الطبية رقم واحد، نقطة الإسعاف في دوما. شاهدتُ المسعفين يتراكضون، بعضهم يقوم بتغسيل المصابين في الطابق الأرضي، وأربعة من المسعفين كانوا يحاولون تثبيت أحد الشبان المصابين لفتح وريد له وهو في حالة اختلاج؛ كانت حدقتا عينيه صغيرتان جداً.
استشهد يومها مصابان، ووُضِع آخرون تحت المراقبة في العناية المشددة، أما الناجون فقد خرجوا من قسم الإسعاف وهم يضعون على أجسادهم شراشف بيضاء. سمعتُ أحدهم يقول للأخر، وهو يضحك محاولاً تخفيف حدّة ما عاشوه: «حاسس حالي بالحج»، لقد استحمَمتُ ورميتُ ثيابي كلّها وغطّوني بالشرشف الأبيض (اللباس الخاص بالحجاج أثناء أداء شعائر الحج).
ورغم تِكرار الهجمات الكيميائية على المنطقة، وجميعها كانت في أوقات متأخرة من الليل، فقد كان أملي كبيراً في أن يكون ثائر قد دقَّ على بابي لأسباب أخرى.
عندما خرجتُ لملاقاة ثائر، كان الشارع معتماً جدّاً ولم أستطع رؤية ملامح وجهه، بل سمعتُ صوته فقط: «هجوم كيماوي كبير … أحضر كاميرتك وتعال بسرعة».
عدتُ إلى باب المنزل أنادي على أهلي كي يستيقظوا ويوقظوا جيراننا في الحي. كان يحركني الخوف، خاصةً أنَّني لا أعرف بعد أين هي المنطقة المستهدفة، وهل يمكن أن يصل الاستهداف إلى الحي الذي أسكُن فيه؛ كنتُ أريدهم أن يبقوا مستيقظين وحذرين.
بالرغم من الخوف، بدأتُ في إعطائهم بعض التعليمات؛ «اجلبوا بعض المناشف بالإضافة إلى عبوات المياه المغلقة حتى تكون نظيفة في حال وصول الغاز السام إلى المنطقة. اصعدوا إلى سطح البناء في حال شعرتم بضيق في التنفس».
رغم شعوري بالذنب على ترك والدَيّ وأخوتي في المنزل، أخذتُ كاميرتي وخرجتُ أركض باتجاه نقطة الإسعاف. عشر دقائق كانت تفصلني عن تلك النقطة، التي هي عبارة عن قبو في أحد الأبنية السكنية منتصف المدينة، وعندما وصلت شاهدتُ المسعفين يضعون بعض المصابين في الطريق، ويقومون بتحميمهم بعد نزع ثيابهم، ومن ثمّ نقلهم عبر الدرج نزولاً إلى قاعة الإسعاف.
عند النظرة الأولى إلى درج القبو، كان مختلفاً عن الذي اعتادته عيناي في حالات القصف، إذ لم يكن هناك بقع دم حمراء، ولم يكن للموت رائحة، ولا حتى رائحة البارود الممزوج مع الدم والركام، ولذلك ربما لم أتوقع من النظرة الأولى للدرج المملوء بالماء الناجم عن تغسيل المصابين حجم الكارثة البشرية. هذه المرة، كانت للموت رائحة مختلفة ضلّلتني عن كل ما سبق.
في قاعة الإسعاف التي كانت تتسع الى سبع أسرة في قسم الطوارئ، وستة أسرة أخرى في غرفة الاستشفاء، بدأتُ أدركُ المشهد الكارثي:
الأسرّة لا تكفي المصابين.
الرجال والنساء والأطفال على الأرض.
رجل ثلاثيني يصرخ ويتقلب يميناً وشمالاً وهو يختلج ولا يستطيع التنفس.
عدد كبير من المصابين يخرج الزبد من أفواههم وأنوفهم .
أفراد الكادر الطبي يصرخون بين بعضهم «أريد أتروبين بسرعة… أنبو… أوكسجين!»، بينما يقاطعهم صراخ المصابين.
أقفُ مكتوف الأيدي، أرتجفُ للحظات، وأعيشُ صدمة للحظات أخرى. قلبي يدق بسرعة، لا أستطيع فعل شيء. أكره عجزي، فأنا لا أجيد فتح الوريد وإعطاء الحقن، ولا أجيد الإنعاش.

أحمل كاميرتي الصغيرة، أقوم بتشغيلها فيظهر صوت رنين خفيف عند التشغيل، وتغيب جميع أصوات الضجيج من حولي ويبقى وحده صوت الكاميرا حاضراً؛ تصبح عيناي امتداداً للكاميرا. ثم أغلقها فتعود تلك الأصوات تطغى على المكان، وأعيد الكرة دون أن أقوم بتوثيق ما يحدث. أقوم بأيقاف تشغيل الكاميرا مرة أخرى، وعلى يساري أسمع أحدهم وكأنه يغني؛ أنظر أليه، إنه صديقي يبكي ودموعه على خديه من هول المشهد، ولا أدري لماذا شعرتُ أن صوت البكاء الخارج من فمه يشبه الغناء.
أقف مع زملائي: عبد الله وياسر وثائر وعمار وأخرين. لا نستطيع التقاط أي صورة. أكره الكاميرا للحظات، ما هي الفائدة من التقاط الصور لهؤلاء الناس، فقد قتل الأسد قبلهم المئات بالقصف بالأسلحة التقليدية، من رصاص القناصة وقذائف الهاون إلى البراميل المتفجرة التي تُرمى من الطيران المروحي، وقصف الطيران الحربي الذي لم يكُ يفارق سماء الغوطة؛ كل هذا ولم يُحرك ساكناً.
هل أنا في خطر من استنشاق الغازات؟ هل سأموت يوماً ما وأنا أحمل هذه الكاميرا؟ هل ستطاردني في أحلامي ويقظتي كل أصوات الصراخ إذا نجوت؟
أنظر إلى أولئك الذين يختلجون أمامي؟ هل يريدون أن أقاتل لأجلهم بكاميرتي؟
يا ترى هل كان يجب أن أبقى مع أهلي في المنزل؟ ماذا لو أصيب أهلي وأنا هنا أصوّر؟
يقطع سلسلة أفكاري المؤلمة صوت من جهة الدرج، يصرخ الدكتور فارس: «ماذا تفعلون؟ قوموا بعملكم، خذوا الصور وأرسلوها إلى القنوات حتى يرى العالم ما يحدث لهذا الشعب فقط لأنه طالب بحقوقه. فقط لأنه قال كلمة حرية يُضرَب بالكيماوي؟».
الدكتور فارس دوما هو طبيب القلبية الوحيد المتبقي في الغوطة المحاصرة، وكان كالعادة يرتدي بيجامته الطبية، فهو مقيم في المشفى منذ بدأ خروج منطقة دوما عن سيطرة النظام.
قمتُ بتشغيل كاميرتي وبدأتُ أطوفُ بها بين المصابين لأصوّر بعض مقاطع الفيديو؛ هنا مجموعة من الشبان مستلقين على الأرض بثيابهم الداخلية وأجسادهم المبللة، شاب من بينهم كان يتقلب ويتخبط بين كراسي الانتظار والحائط المقابل له وكأنّ روحه تُنتَزع من داخله، وفي جهة أخرى مجموعة من المصابين يرتجفون ويختلجون والزبد يخرج من أفواههم وأنوفهم.
هناك اثنان من الممرضين يحملون جهاز الأنبو وجهاز التنبيب، وبين أيديهم طفل صغير يحاولون فتح وريد له، وإلى جانبهم طفلة ترتدي بلوزة حمراء عليها بعض القطع البراقة وبنطال جينز، كانت تأخذ أنفاساً بطريقة غريبة مترافقة بحركة من الرأس وجحوظ في العيون، هذا بعد أن تلقت بعضاً من العلاج.
طاولة المكتب السوداء على الجانب الأيمن للغرفة، في المنطقة الفاصلة بين غرفة الإسعاف وغرفة الاستشفاء، والتي يوضع عليها عادة سجل المرضى ومن خلفها خزانتان للأدوية والمستلزمات الطبية؛ امتلأت الطاولة يومها بالحقن وأنبولات الأتروبين والقثاطر الوريدية.
إلى جوار الطاولة كان هناك شاب عشريني بدأ بالتحسن قليلاً، وكان ينظر باتجاهي بعينين حمراوتين وحدقات متضيقة؛ سألته أين كنت؟ ماذا حدث؟
قال: «كنا بزملكا نايمين. سمعنا صوت أربع قذائف، بس ما في صوت سقوط شظايا. غريبة؟ ما اهتمينا، بقينا، وبعدها حسينا داق تنفسنا، نزلنا على الحارة وقربت على الأبنية فبدأت أرى سيارات مسرعة، بدأنا بدخول الأبنية، وكلّما ندخل على منزل نرى الجميع، نساء وأطفال ورجال، مغمى عليهم في أرض المنزل . بدأنا بحملهم وإنزالهم، نعمل ونعمل ولم ينتهي العدد».
في نهاية كلامه قال هو يبكي: «ما لح نستسلم حتى نسقط هذا النظام… أي والله لنسقطّه أي والله لنسقطّه».
لم يكن لديه شك، لم يكن لدى أحدنا أي شك، ولا حتى ترف النقاش حول مسؤولية النظام عن ضربنا. كنّا متأكّدين أنه سيستعمل كل ما في جعبته من أسلحة ليخنق حلم جيلنا بالحرية.
أثناء الحديث، يركض أحد المسعفين من جانبي تجاه مصاب كان مستلقياً على الأرض، يرتدي بيجامته الزرقاء وهو جاحظ العينين؛ ينطق الشهادتين مشيراً بإصبع السبابة اليمنى، ثمّ يصرخ وينادي صديقه: «أبو الجود أبو الجود…. أمانة برقبتَك أمي». أنظر إليه، إنّه محمد، مسعفٌ من الكادر الطبّي وقد تعرض للإصابة نتيجة الاحتكاك المستمر بالمصابين أثناء إسعافهم من مكان الضربة؛ كان يختلج فيما يحاول بقية الزملاء تهدئته وإنقاذه.
وسط تلك القاعة، عادت بي الذاكرة إلى العام 2009، عندما كنت في الخدمة العسكرية الإلزامية في كلية الحرب الكيميائية التابعة للجيش السوري في مدينة حمص، وكنتُ في درس أتدرّبُ على أساليب الوقاية ومعدات تعقيم إصابات السلاح الكيماوي، لأنه في حال استخدم هذا السلاح ضدنا من قبل العدو، فإننا سنكون نحن عناصر الجيش العربي السوري على أهبة الاستعداد لمساعدة أهلنا.
وقتها سألتُ الضابط المسؤول، الرائد بشار: سيدي هل نمتلك السلاح الكيماوي؟
فأجابني بغضب: اخرس واجلس مكانك. نحن فقط دفاع كيميائي.
فتحدثت مرة أخرى: إذن لماذا لم تُسمّى هذه الكلية باسم كلية الدفاع الكيميائي؟
نظر إلي وقال: أتريد أن تنام الليلة في السجن؟
تابعت تدريبي يومها، لكن لم يخطر في بالي تلك اللحظة أنّ لدينا سلاحاً كيميائياً، أو أن الجيش السوري سيستخدمه، في حال وجوده، ضد الشعب السوري.
أعود من ذاكرتي مع تلك المحادثة إلى ما نحن فيه؛ ضجيج الإسعاف وأصوات الناس المصابين.
أمضينا طوال الليل في قسم الإسعاف، وما زال عدد المصابين بازدياد. في الصباح الباكر، قرّرتُ الخروج من قسم الإسعاف. لا أدري إن كنت قرّرتُ المغادرة كي أرفع الفيديوهات التي صورتُها حتى يرى العالم ما يحدث، أم أنّني لم أعد قادراً على تحمل التحديق في المزيد من الأجساد المختلجة.
على باب الخروج التقيت بشاب قادم من ميكروباص، يحمل بين يديه طفلة رضيعة ترتدي بيجاما حمراء اللون، ويركض بها مسرعاً على الدرج. ركضتُ عائداً خلفه، مجهزاً كاميرتي دون تفكير. يضع الطفلة على السرير ليبدأ أحد الأطباء بفحصها، يفتح عينيها الصغيرتين وينظر فيهما ثم يمسك بسمّاعته الطبية لفحص القلب والصدر، ثم يقول «ما في نبض»، توفيت تلك الطفلة اختناقاً. رافقتُ المسعفين لنقلها إلى قسم الوفيات في الطابق الأرضي، وقمت بتعداد الجثامين؛ 32 جثماناً في قسم الإسعاف في مدينة دوما، بينما تمّ نقل جثث المتوفين البقية إلى نقطة الدفاع المدني. اثنان وثلاثون جثماناً بلا معلومات، فلم يكن قد أتى أحد ليتعرف عليهم كالمعتاد، ولم يكن لدى أحد شيءٌ يدلُّ على هويتهم لأن معظمهم كانوا نياماً.
بعد تصوير تلك الطفلة، أجبرتُ نفسي على الخروج من هذا المكان المغلق الممتلئ بالموت، فأخذتُ أمشي في شارع خورشيد أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، ثم دخلتُ زقاقاً على يساره أبنية طابقية وعلى يمينه بيوت قديمة من الطين. في الطريق لا يوجد سوى صوتُ السيّارات التي تنقل المصابين بأضوائها السريعة، مترافقةً مع صوت أذان الفجر في ذلك الوقت.
مشيتُ متوجهاً الى مدرسة الحسن البصري التي تبعد قرابة عشر دقائق سيراً على الأقدام، والتي تمّ تحويلها إلى مركز تحميم وتعقيم، لأنه بعد تكرار استخدام السلاح الكيماوي كان هناك حاجة لإنشاء مركز كهذا في المدينة، فنقطة الإسعاف صغيرة وهي ضمن قبو سكني مغلق، بينما يحتاج علاج حالات الاختناق بالغازات السامة منطقة مفتوحة ومصدراً للمياه، ولهذا تم تجهيز باحة المدرسة التي يتوسطها ملعب لكرة السلة، وذلك بمدّ خراطيم مياه من البئر المركزي في المدرسة إلى عدة نقاط متباعدة داخل باحة المدرسة.
في هذه المدرسة، تم توجيه مجموعة من المسعفين ليقوموا بعلاج المصابين الأقل خطورة، فعملهم يعتمد على إعطاء بعض الموسعات القصبية والتغسيل من آثار الغاز السام. كنتُ أطوف بين الصفوف في المدرسة، داخل كل صف يوجد قرابة العشرين شخصاً بالإضافة إلى ممرضٍ يقوم بمتابعتهم، وفي حال ساءت حالة أيّ شخص يقوم بتحويله إلى قسم الإسعاف.
لم أستطع أن أبقى طويلاً في ذاك المكان، إذ يجب أن أذهب لأقوم بتحميل مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب حتى تكون متاحةً لكلِّ العالم.
خرجتُ متّجهاً إلى مكتب الدكتور محمد، الذي كان ملاصقاً لنقطة التحميم والتعقيم، وهو طبيب أسنان كان يعمل وقتها مسؤول التواصل لدى المكتب الطبي في مدينة دوما. جلستُ لأستمع للدكتور محمد أثناء مداخلته على إحدى القنوات وهو يقول: «الآن العدد أكثر من 500، ولكن لا نستطيع حصر العدد الآن، فنحن بحالة إسعاف المصابين وعلاجهم».
بعد أن انتهيتُ من عملي مؤقتاً في الصباح، ذهبتُ لأطمئن على أهلي، وأخبرتهم بما حدث إذ لم يكن لديهم أي وسيلة للحصول على الأخبار في وقتها. اطمأننتُ عليهم واحداً تلو الآخر، لكنّي لم أجد أخي الأصغر معهم بالغرفة، فقد كان يجلس في غرفة أخرى. دخلتُ عليه. كان حزيناً يبكي، فقد كان يملك عصفورين من نوع «العاشق والمعشوق»، ولكن عندما كان يتفقد طعامهم وشرابهم في الصباح كانا مستلقيان داخل القفص وقد فارقا الحياة.
كان هذا اليوم من الأيام الأصعب التي مرت علينا منذ بداية الثورة، ولأيام بعدها لم أستطع النوم، أخاف أن أنام وأستيقظ على خبر هجمة أخرى، أو أن لا استيقظ ابداً.
بعد أيام تكشَّفت الحقائق عن أعداد الضحايا، إذ أفاد تصريحٌ للمكتب الطبي في الغوطة الشرقية بأنّ عدد الإصابات قد وصل إلى العشرة آلاف مصاب، و1347 شهيداً من المدنيين بينهم أفراد عائلات بأكملها، صعدت أرواحهم إلى السماء بأجساد كاملة. وحده السلاح الكيماوي الذي كان يسمح بالموت قطعة واحدة. في ذلك اليوم، لم يكن هناك حاجة لغرف العمليات والخيطان الجراحية، ولا لأكياس الدم والمآذن التي تنادي بطلب المتبرعين بالدم.
وحدهُ صوت الطائرات والقصف على أطراف الغوطة خيّم على كل ليالينا، وساعد في تغذية الأرق والهواجس حول ما إذا كان النظام سَيستطيع الدخول إلى المنطقة بعد هذا الهجوم، كما كنّا ننتظر إذا ما كان هناك أيّ تدخل سيقوم به المجتمع الدولي لمحاسبة الأسد على هذه المجزرة، وعلى استخدامه السلاح الكيميائي المحرم دولياً.
أكتب هذه الذكرى الآن بعد سبع سنوات، وأوجهها إلى رفاق الثورة الذين شاهدوا هذه الفظاعة عبر أشرطة الفيديو والصور فقط، أسردُ هذه الذاكرة لأضعها بين يدي من يناصرون هذه القضية ويعملون على ملاحقة الجناة ومجابهة الجيوش التي تقاتل إلى جانبهم.
من أجل سوريا ومن أجل الثورة ومن أجل التاريخ، نناضل بهذه الكلمات حتى تحيا قصصُنا السوريّة، إيماناً بالحرية والعدالة لضحايا هذه الهجمات الإجرامية.
تاريخ المقال 20 أغسطس 2020